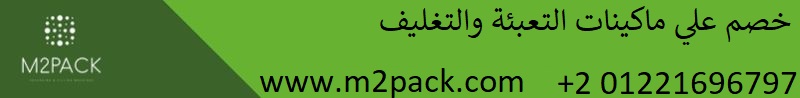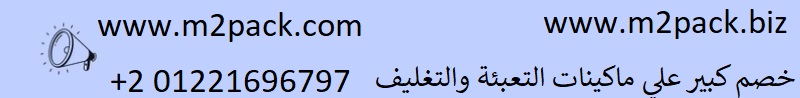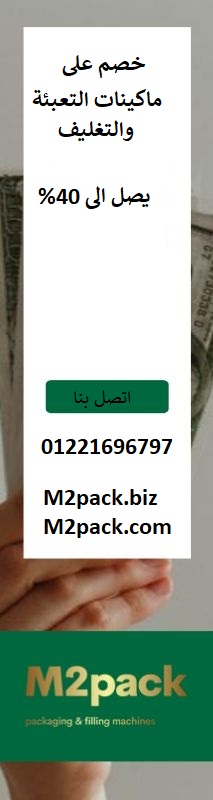الجنس الأدبي بين الذاكرة والتركة

ينبغي التمييز بين الذاكرة والتركة؛ فالأولى فردية على الرغم من كونها خاصية كونية حيوية، يُستنَد في تأكيد موضوعها أو نفيه إلى الفرد المُستذكِر، وهي غير قابلة للتداول إلا في الجانب الذي يكُون فيه موضوعُها مُتقاسَما في أثناء حدوثه مع آخرين، بما يفيده هذا الأمر من أسرار وخفايا وتوهمات وتحويرات.
بينما تُعَد التركة ما تنتقل ملكيتُه (و/ أو المسؤولية عنه) من يد إلى يد، ومن ثمة لا تتصف بكونها فردانية، وهي علنية، ولا بد أن تكُون كذلك حتى تكتسب شرعيتها. وتُعَد التركةُ الموطنَ الذي يتقاسمُ الحضورَ فيه كل من التاريخ والذاكرة الجماعية والجنس الأدبي؛ كما أنها تُعَد موضوعا للذاكرة. ومن الأكيد أن هذا الاختلاف ينسحب على طبيعة علاقة الجنس الأدبي بالتركة، ومن ثمة لا يُمْكِن إجراء قياس- في هذا الجانب- لاشتغال الذاكرة في الأدب على اشتغالها النفسي في حياة الأفراد؛ إذ تتمثل فاعلية التركة الأدبية في فعل الاستحضار بما يُفيده من مَظْهَريْن مُمَيزيْن: ا- مظهر استدعاء الغائب (التركة: الجنس الأدبي) وفق أسس ثلاثة: التمثيل (الشكل أو الإطار الذي يتكون من خاصيات عامة) والتمثل (الصورة المُختزنة بوصفها فهما ثقافيا أو سجلا: فنا راقيا أو مُنحطا، بورجوزايا أو شعبيا، جديا أو هزليا، مُفيدا أو غير مُفيد…الخ ) والنسق الثقافي (الذي يسمح بتأويل العالم: الالتباس، الوضوح، العبث، المسؤولية، التنسيب، اللانهائي، الميتافيزيقي، الرفض، القبول، التصالح…الخ).
ب- مظهر رد الفعل: التطابق مع التركة (الجنس الأدبي) أو عدمه. ويتمثل فعل الاستحضار في هذا المظهر الثاني بقوة، وربما كان هو ما يُميز التركة من الذاكرة؛ فإذا كانت الأولى تنتهي إلى الكاتب من أسلافه في هيئة نصوص، وتعليمات، وقواعد، فإن المطلوب منه ليس فقط استعادتها فحسب، بل أيضا التعامل معها قبولا أو رفضا، مع ما يعنيه ذلك من استبدال أو تغيير. بينما لا تَرِدُ هذه الاتصافات في مجال الذاكرة المحضة؛ فليس واردا فيها أن يقبل المرء مُحتويات الماضي أو يرفضها أو يستبدلها، ما وقع في الماضي قد وقع وانتهى، وكل ما يُستطاع هو إخفاء الأمر أو تحويره؛ وما يحدث في حالة التحوير ليس التذكر أو الاستذكار، وإنما تخيل ما لم يقع أو توهمه؛ ومن ثمة يتمثل فعل استدعاء الماضي- في هذه الحالة – في عملية إنكاره. ويتعين الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه فعل الاستحضار الأدبي في الوسط، في المسافة التي تفصل التركة (النصوص السابقة والأوفاق والقواعد والسنن…الخ) عن المُنتَج الراهن (النص المُفْرَد). هكذا يكُون الاستحضار الأدبي تاما وفق حالات ثلاث: إما أن يكُون تذكرا غيرَ واعٍ من قِبَل الكاتب أو استذكارا واعيا، وإما استذكارا واعيا من جهة المُنظر. فالأديب قد يستذكر في أثناء كتابته- على نحو واعٍ – إجراءات فنية مُعينة، أو نصا، أو مجموعة من النصوص على مُستوى الأداء (الكتابة) فيميل إلى استعادتها في ثنايا مُنتَجه، وقد لا يستذكِر الإجراءات والنصوص السابقة، فتتسلل إلى نصه على نَحْوٍ غير واعٍ؛ فيكُون نتيجة هذا مظهر التناص بوصفه دليلا ملموسا على اشتغال التركة (جوليا كريستيفا)، واستعادتها، ولا يخلو عددٌ من الكتابات التي تناولت التناص من الإشارة إلى الربط بينه وبين الذاكرة، بيد أن من الأفضل ألا يُؤخذ الربطُ الآلي بينهما على محمل الجد، نظرا للمُلاحظات التي أشرنا إليها أعلاه، خاصة حين يحصل الإدراك بكون الحدث النصي يقبل إعادة الإنتاج، ويقبل التحوير، وهاتان الخاصيتان تُقوضان الذاكرة، وتجعلان من الفعل الذي يطولها مُندرِجا في مجال التخيل والتوهم. كما لا يُمْكِن غض الطرف – في مجال الترابط بين هوية الجنس الأدبي وتعرفه داخل مجال التداول- عن طقسية فعل الاستحضار الأدبي؛ فيكُون هذا الأخير شبيها بما تتصف به طقوس الجماعات وتقاليدها من إحياء لرموزها التاريخية والثقافية وتخليدها حتى تضمن لها التعرف إلى نفسها، وتأكيد هويتها، والحفاظ عليها مُستمِرة في الزمان.
هكذا تكُون استعادة التركة في الأدب نوعا من ضمان تعرفه إلى نفسه، وتأكيد هويته بغية الاستمرار في الزمان. بيد أن مُشكلة نظرية أكثر منها إجرائية تُواجهنا في هذا السياق: كيف يستحضر النص الأدبي تركته (الجنس الأدبي)، ويستذكرها ليضمن انتماءه إلى هوية مُحددة تُسهل مأمورية تعرفه إلى نفسه، وتعرفه من قِبَل القراء، إذا كانت الخاصية التي تُميز الأدب ماثلة في مُغايرتِه ما سبقه من نصوص ونماذج؟ لا خيار لنا أمام مُشكلة من هذا الصنف سوى حليْن لا ثالث لهما: إما أن نَعُد التخييل الأدبي ضد كل تركة، وكل فاعلية استحضار هوياتية مُؤسسة على الاستمرار والتطابق، فيصير كل النقاش الذي أجريناه لا قيمة له، وإما أن نَعُده مُمارسة قائمة على استهداف مُتنامٍ مُرتبط بالزمان والمكان، وبعوامل التكيف، بما يعنيه ذلك من ترسب وتجديد بالمعنى الذي طرحهما به بول ريكور في كتابه «من النص إلى العمل». ربما كان الحل الثاني الأنسب، لا رغبة في إنقاذ ما سلف من القول، بل تأكيدا للمنظور التجديلي الذي لا مجال فيه للقطائع الجذرية. ومن ثمة فالأدب قائمٌ على التجديل بين فعلي الاستحضار والنسيان، والانحياز إلى أحد الفعلين يُحدد علاقة الإنتاج الأدبي بالتركة والتقاليد؛ فالمُكتَتِبُ والكاتب رولان بارت: نقد وحقيقة، هما صورتان لهذا الانحياز؛ إذ يتطابق الأول مع المعايير المُلزمة لجنس أدبي مُعين، ويتم فعل إنتاجه وفق استحضار التركة ومُراعاتها، ولا تهم درجة قوة هذا الاستحضار، بينما يصعب الحديث عن الاستحضار بهذا المعنى بالنسبة إلى الثاني (الكاتب)؛ إذ تُقام مُمارسة الإنتاج الأدبي لديه على تدمير مفهوم الجنس الأدبي (التركة)، وعلى رفض كل أشكال التواصل المُؤسسة على التبادل، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة تيل كيل كتاب «نظرية المجموعة»، وقبلها المُنظر الإيطالي بندتو كروتشه. ولا يستقيم هذا النقاش إلا في ضوء نزع الأوهام المُتصلة بنشأة الأدب، وظهور إشكالية الجنس الأدبي. وهاتان مُهمتان سنُخصص لهما المقاليْن المُقبِليْن.
أديب وأكاديمي مغربي