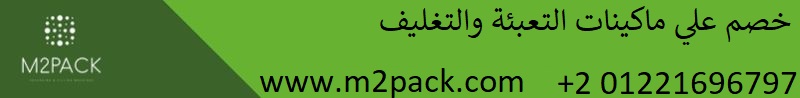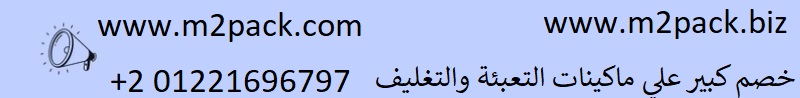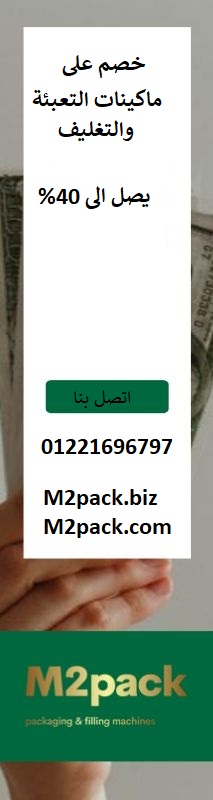السيرة الذاتية الروائية في السياق العربي

في سبعينيات القرن الماضي، استعمل الناقد الفرنسي سيرغ دوبروفسكي عبارة autofiction لكي يُعرّف كتابه المنشور تحت عنوان Fils (ابن).
يرفض دوبروفسكي تعريف السيرة الذاتية التقليدية الخاصة بأشخاص معروفين أو مهمين يروون في آخر أيام حياتهم وبأسلوب جميل أحداث ووقائع مرّوا بها. وضع الناقد الفرنسي فيليب لوجون في كتابه Le pacte autobiographique معيارين أساسيين في تعريف السيرة الذاتية: أولهما وحدة الهوية بين الكاتب والراوي والشخصية الرئيسية. وثانيهما التزام الكاتب تجاه القارئ: عليه أن يروي أحداثا حقيقية بصدق ولا يكذب. إذن السيرة الذاتية مبنية على مفهوم الذات التقليدي.
أما دوبروفسكي، فيعتمد على منهجية مختلفة تماماً: يأخذ بسياق زمني لا واقعي: 24 ساعة من حياته كأستاذ جامعة في نيويورك. يتناول ضمن هذا الإطار الخيالي أحداث حياته، بدون أن يحترم التسلسلَ الزمني ولا المنطق. عمليا يجعل اللغة تقود الكتابة والذكريات، وتقوم بتحليل الأحداث بشكل مستمر، كما يفعل المحلل النفساني. بالمختصر: يتبرأ صاحب السيرة الذاتية الروائية من مفهوم «الحقيقة» ومن مفهوم الذات الواحدة التقليدية.
وهذا ما جعل بعض النقّاد، بمن فيهم فينسان كولونا، يصفون هذا الجنس بأنه محاولة لكتابة سيرة ذاتية في عصر ما بعد فرويد. والواقع أن ظهورها في المجال النقدي تسبّب في نقاشات عديدة حول تعريفها غير المستقر لحد الآن. إذن هل يوجد جنس أدبي عربي يشبه ما نسميه في الأدب الأوروبي مصطلح autofiction القائم على مزيج من الواقع والخيال؟
في السياق العربي الأمور مختلفة جداً بسبب الدور المهم الذي لعبته السيرة الذاتية أدبياً واجتماعياً في إبراز الذات وإنشائها. بالطبع عرف الأدب العربي في كافة عصوره نوعا من التعبير عن النفس.
غير أن الكتّاب بدأوا منذ النهضة الثقافية وبتأثير الفكر الأوروبي بكتابة سِيَرذاتية، لكن بشكل مختلف عن النمط الأوروبي، بسبب اختلاف الغاية أو الأهداف المرجوة. في هذه الفترة طمحَ المثقفون الملتزمون إلى أن يلعبوا دوراً في تحديث مجتمعاتهم، ما يقتضي إبراز الفرد، فأخذوا يروون أحداث حياتهم، شأن السفر إلى أوروبا للدراسة، فترة التعليم والتثقيف، علاقتهم بالمجتمع الأجنبي والعربي، دورهم في وطنهم إلخ.
إذن كانت هناكَ دائماُ غاية تعليمية: الكاتب يعلّمُ القارئ أدبياً وسياسياً واجتماعياً، من باب المسؤولية. في الوقت ذاته يجبره دوره على أن يرّكزَ على البعد الاجتماعي، ما يمنعه عن سرد الكثير من الأحداث (لاسيما تلك المرتبطة بمواضيع مثل الدين أو الجنس أو العواطف إلخ).
لا بد في هذا السياق أن يكون التعبير عن النفس محدوداً، حتى لو حاول الكتّاب أن يعبروا عن الذات بشكل أعمق بعد منعطف الستينيات، وخصوصا بعد الثمانينيات.
هل ظهرت السيرة الذاتية الروائية كحل لتعبير أعمق عن النفس؟
منذ التسعينيات يستخدم النقد العربي خصوصا النقد المغربي هذا التعبير المأخوذ من اللغة الفرنسية، كي يعرّف هذا النوع الجديد من العمل الأدبي. لكن تعريفه وإن كان غير مستقر ولا يشبه مثيله في الفرنسية. والواقع أننا نستطيع أن نميز بعض الميزات الخاصة بالسيرة الذاتية الروائية في السياق العربي. نأخذ مثالين ينتميان، في رأينا، لهذا الجنس الأدبي: «ذاكرة للنسيان» لمحمود درويش أو «الضوء الأزرق» لحسين البرغوثي، لأننا نستطيع أن نرى فيهما نوعا من التشابه.
أولا تعدد الأصوات: لا يسمع القارئ صوتا واحداً – صوت الكاتب- بل أصوات كثيرة: الحوار مع النفس، مع الآخرين، مع المكان، ذكر كُتاب سابقين وأدبهم، مزيج بين النثر والشعر، بين الحلم والواقع، والماضي والحاضر. لابد أن هذا المزيج ووجود عناصر خيالية ساعدت كثيراً على استذكار ثم سرد وقائع حياتهم بشكل أعمق وأصدق وكذلك على تجنب الرقابة.
ثانيا، جميع هذه الأصوات مضمّنة في إطار صغير: بالنسبة ل«ذاكرة للنسيان» السياق هو الصباح في شقته في بيروت أثناء الحرب. أما عند البرغوثي السياق هو الحوار الطويل مع شخصية غريبة بين المتسوّل والصوفي. هذا الحدث المهم يشمل جميع الأحداث.
أخيرا، جميع هذه الأمور أثرت على علاقة الكاتب بالمجتمع: لم تعد لديه مسؤولية تجاهه، بل أصبح المجتمع عنصراً أساسياً في إنشاء الذات. لم يعد الكاتب يقود المجتمع بل يبني نفسه من خلال علاقته به أيضاً.
٭ كاتبة سورية