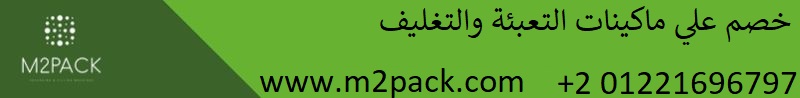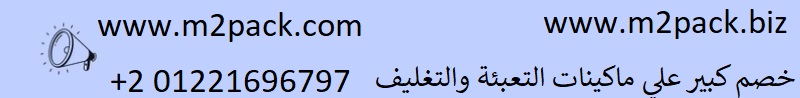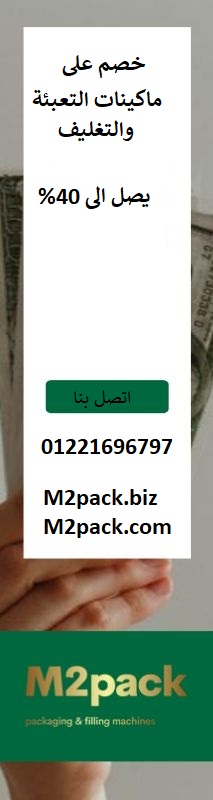العمانية هدى حمد… تعدّ السلالم المنبسطة

بعد مئة صفحة من الإحماء نسمع الخطوات الأولى للمرأة الغامضة «التي تعدّ السلالم»، حيث تستطرد هدى حمد طويلاً في تأثيث روايتها الصادرة عن دار الآداب، قبل أن ترمي بأول لقطة يمكن بها توتير النص درامياً، وفتح الرواية على سيناريوهات استيهامية، وكأنها تبحث عن الخيط الضائع الذي تنسج به حبكة الرواية، إلا أنها تواصل في ما بعد سردها الواقعي المطعّم بشيء من الغرائبية، التي تقوم على المادة الحُلمية للمنامات، إلى أن تنتهي الرواية بمآلات شخصية وخطوط سردية متوازية لا تلتئم في عُقدة فنية مقنعة، فالرواية في المقام الأول هي بناء عالم، أي اقتطاع لحظة زمنية وتضمينها أحداثاً وشخصيات داخل وحدة قوامها الانسجام،
لحظة المرور الطيفي للمرأة التي حلمت بها العاملة الإثيوبية (فانيش) منتحرة في البيت، جاءت مباغتة، وكأنها تنقل السرد إلى منعطف آخر أكثر دراماتيكية، حيث تنتاب القارئ رعدّة محتّمة بهول المفاجأة، وبعبارات هدى حمد الذكية في هذا المفصل «إن لم يكن ماضي امرأة، هل يمكن أن يكون مستقبل امرأة»، حيث تزرع هذه العبارة وما يعادلها حالة من القلق والرعب والترقُّب في البيت الآمن السعيد، كما تضفي على سياقات الرواية أيضاً شيئاً من التوتر الدرامي، بمعنى أن المادة الحياتية الخام، بدأت تتبأر في نقطة مركزية، يمكن أن تشكل حبكة الرواية، إلا أن هذا الإفتراض لم يتحقق، ربما لأنها تحركت في مساحات موضوعية تمنع استجماع خطوط الحكاية في مصب واحد، أو لأنها لم تسمح للمادة المحكية بالاختمار الأدبي اللازم.
ويبدو أنها أعدت ثلاث حبكات، واحدة أصلية وحبكتين مساندتين، إلا أنها لم تتمكن من إنضاج أي حبكة منها، ولم تجتهد بما يكفي لمفاعلة الحبكات الثلاث كما ينبغي. الحبكة الأولى تتمثل في قصة «زهّية» الفنانة المسكونة بهوس الأناقة والنظافة ومعاداة كل كائن لا تجري فيه الدماء العُمانية، على الرغم من نضالها الاجتماعي للزواج من عامر، ابن الأفريقية (بي سورا). وتتجسد الثانية في حكاية زوجها عامر مهندس البترول والكاتب، الذي يسافر إلى زنجبار بحثاً عن والدته، فيما تنعقد الحبكة الثالثة حول العاملة المنزلية (فانيش) التي تكتب هي الأخرى سيرة عذاباتها من حقول البن في إثيوبيا، وصولاً إلى عمان، مروراً بالسعودية، حيث تم إغواؤها بالدخول في الإسلام لتحسين وضعها الإنساني.
هدى حمد تعي جيداً الموضوع الذي سترويه، وتجيد مراكمة خام المادة اللازمة لذلك، إلا أن تسريد ذلك الخزين من المعارف والأحاسيس لا يأخذ شكله البنائي المأمول، كذلك لغتها شفافة ومعبّرة تنساب برشاقة بين التفاصيل، وترفع منسوب التشويق، خصوصاً في ما يتعلق بمزاج المرأة وحميمياتها، وكأنها تثبّت عيناً فاحصة لرصد عوالم المرأة التي ترسم مفاصل هويتها، من خلال حضورها الجسدي والشعوري، إلا أنها تصاب بالارتباك والتقريرية عندما تغادر هذا النبع الأنثوي إلى الفضاء الاجتماعي، حيث تتصلب اللغة وتسقط في الخطابية، فالأنوثة الناعمة التي تخدش السطح الاجتماعي لتشكل مجراها الحقوقي الإنساني، سرعان ما تنحرف عن مسارها إلى مصبات موضوعية، وعلى هذا الأساس يمكن قراءة تموضعات «زهيّة» التي تقرأ بدورها مسودة رواية «عامر» من جهة، ومذكرات «فانيش» من جهة أخرى، وكأنها تطالع موضوعات غير محكوكة بالأحاسيس.
ولأنها تريد استدخال كل ما يمر بها في الرواية، وتوظيف كل ما يعترضها أو تستدعيه لإدانة العنصرية، بما هي ثيمة الرواية ونقطة ارتكازها، أو اختلاق طريقة ما باتجاه هذا الهدف، حيث صارت تعدّد تفاصيل مكوّن الفضاء العُماني، باستنطاق جينات المكان، واستعراض الأدوات الاستعمالية والأزياء والأكلات الشعبية كجزء من مركبات الهوية، وعرض مآثر وعوالم وخلفيات عامر وفانيش، ولكن بدون تلك العدة السردية التي تعجن اللغة في عبارات دالّة، بل بشيء من التقريرية المباشرة، حيث تم تقديم «منيو» الطعام الإثيوبي في ما يشبه العرض البانورامي، وبدون أن يلتحم ذلك المكوّن الحسّي بضرورات واشتراطات النص الفنية، كما تم استعراض تاريخ العبودية، الذي يفترض أن يستدمجه عامر في روايته، كمعلومة إرشيفية وليس كوخزة مستفزة للضمير.
وهذا هو بالتحديد ما أربك عنصر الإيقاع في الرواية، فعرض السهرة في بيت العم حمدان والعمة جوخة، استغرق قرابة العشرين صفحة، فيما تم المرور على أحداث زمنية طويلة بسطور أو عبارات قليلة، الأمر الذي أفقد السرد توازنه، حيث تشبّعت بعض المشاهد بالتفاصيل والمعلومات والأحاسيس، مقابل عبورات سطحية على مشاهد أخرى، وهذا التجاوز لم يحدث من منظور فني، إنما نتيجة ارتباك في توزيع المادة الخام من خزين هدى حمد المعرفي والحسّي، بمعنى أنها لم تبسط النص وفق معيارية سردية مدروسة، أو وفق مسطرة سردية وازنة للجرعات اللغوية والمعرفية، بقدر ما تركت السرد يتدفق بمقتضى الحالة الشعورية التي تكتب بها.
هذا لا يعني أنها تكتب عفو الخاطر، بل من واقع مختبر له خصائصه ومرئياته الفنية والمعرفية، فهي تجيد قياس كمية المعنى المراد حقنه في كل جُملة، والإمساك بالطاقة الحسّية لخام الحياة المتأملة، وتفخيخ النص بالعلامات، وتجسير العلاقات بين شخصياتها الممتلئة داخل نظام بنائي تركيبي، ففي بداية الرواية ينزرع عامر في عنق زهيّة ليلة زواجهما كقرنفلة، وتنفلت منه كلمة (ماه)، فيما يوحي باسباغه سمة الأمومة عليها، إلى أن ينجلي سر تلك الآهة في آخر الرواية بعبارتها «أدركت شيئاً غاب عن بالي، عامر يبحث عن أمّه فيّ أنا»، فقد كان عامر يكتب «عن شيء وحشي»، حيث كادت الكتابة «أن تحوله إلى رجل آخر لا أعرفه».
كذلك يمكن التقاط الخيط الخفي المشدود ما بين عامر وفانيش، فهو دائم الحديث معها منذ لحظة استقبالهما لها، وقد أعطاها كتب ابنه يوسف وابنته راية لتقرأها، كما أهداها تذكاراً أفريقياً إثر عودته من زنجبار، في ما يبدو محاولة للالتصاق – الواعي أو اللاواعي – بشيء من تاريخه والمكان الذي يدين له بشيء من وجوده، أما هي فقد كتبت في مذكراتها ما يؤكد هذا المنزع «أنتشي برائحة عطر السيد عامر، وأنا أكوي ملابسه، أتمنى ألاّ تنتهي ثيابه، كأنني على موعد معه». وفي مقطع آخر تعمّق الحفر باتجاهه «لونه الغامق في كل الأشياء التي أحب، قارتي السوداء وقهوتي»، وهنا تتضح قدرتها على معالجة الوقائع في مصهر إبداعي.
كل ذلك يشير إلى هوية عُمانية متشظية تحاول هدى حمد استجماعها داخل رواية، وذلك عن طريق تصالُّح البطلة مع ذاتها في المقام الأول، وإقرارها بأن الماضي والحاضر يمكن أن يتكاملا في ذات واعية، وفي لحظة منفتحة، وأن الأعراق والأجناس الصافية لم تعد ممكنة الوجود ولا الفاعلية، وأنها لن تقبل بمنطق جد عامر وقسوته عندما أخبره أبو عامر بزواجه من أفريقية «ودّ الكلب، خلطت العرق يا ودّ الكلب»، حتى عندما قررت زهيّة أن ترسم فانيش، لم تتمكن من مقاربة ملامحها ما دامت في هيئة ورثاثة العاملة المنزلية، ولذلك نزعت عنها ذلك المسوح الاستعبادي وصاحبتها كصديقة ونديمة، بعد أن دافعت عنها ضد صديقاتها الأرستقراطيات، فهي فرد من العائلة الآن، أي جزء من الهوية المركبة.
هذا ما أرادت أن تقوله هدى حمد، أي رسم الخط البياني لسيرة زهيّة المتغطرسة، التي تتفنن في حبس العاملة المنزلية في مربع وجودي لا تسمح لها بالخروج منه، وتتأفف من كل ما لا يتناسب مع طباعها الحادة ومزاجها المتقلب، وتعشق العاملة التي تستجيب لإملاءاتها بشكل آلي لتشبه (الروبوت)، وكأن تلك المخلوقات بلا مشاعر ولا طموحات، لدرجة أنها أجازت لنفسها سرقة يوميات فانيش وقراءتها، وهذا الإغراق في وصف العلاقة المتوترة بينها وبين العاملات، هو الذي سمح للغة الاجتماعية بالغلبة، وتراجع اللغة الإيحائية، وتقليل فُرص حضور خط التوتر الدرامي الذي دفعها إلى التبدُّل، وكأن انهيار عالمها الاستثنائي، وشخصيتها الساطية، قد تم بشكل فجائي بيد الروائية هدى حمد، وليس بموجب صيرورة عبرتها الراوية زهيّة.
إن تسلسل الأحداث وتشابكها في رواية «التي تعدّ السلالم» قد يعني أن هدى حمد قد أمسكت بخيوط الحكاية، ولكن البنية الفكرية للنص، المتمثلة في الحبكة، والقائمة على الصراع، بمعناه التصعيدي تحديداً لم يكن حاضراً بما يكفي، حيث تعيش زهيّة حالة من الصراع مع ذاتها ومع محيطها، ولكن بدون أن تأخذ تلك المجابهة شكل وبنائية الحبكة، فالسلالم المنذورة للعدّ المتصاعد، كما يوحي عنوان الرواية، لا تُدخل البطلة في حالة من الاختناقات الشعورية الفكرية الحادة، بقدر ما تنبسط أمامها كهاوية أفقية، وهو الأمر الذي جعل النص في مفاصل منه يبدو مشتتاً وتقريرياً، بل فائضاً بمعلومات وزيادات كلامية لا حاجة لها، بسبب ضعف الحبكة المسؤولة عن هيكلة النص، أي السؤال الدرامي بالمعنى الأرسطي، الذي يدفع الشخصيات لارتباكاتها وانعطافاتها وأداء أدوارها الفاعلة.
كاتب سعودي
محمد العباس